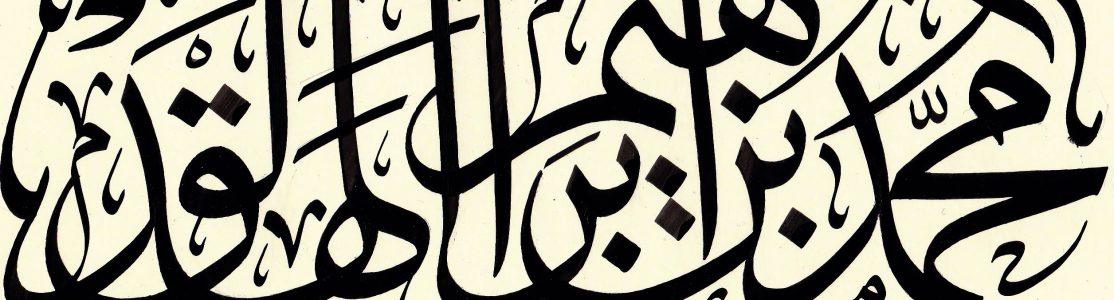طالما أننا نعيش مصيراً واحداً قد ألجأنا إليه هذا الميكروب، وجعل الناس فيه سواسية كأسنان الحمار..
شارك هذا الموضوع:
- المشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
- شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
- اطبع (فتح في نافذة جديدة) طباعة
- المشاركة على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
- المشاركة على Reddit (فتح في نافذة جديدة) Reddit
- مشاركة على Tumblr (فتح في نافذة جديدة) Tumblr
- المشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة) Pinterest
- المشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) Telegram
- المشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
- إرسال رابط بالبريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني